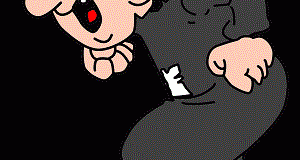سواء كان المسح سطحيّا أو هو التمحيص الدقيق بالمعنى الأكاديمي، يكون الجزم القاطع بغياب الطرح الاجتماعي (وإن كان في بعده النظري) عن خطاب جميع الفصائل المكوّنة للمجتمع السياسي برمتّه، سواء المتحكّم في «السلطة والمال والسلاح» أو من يقابله من المتشبثين بما هي «شرعيّة» لا تجد شرعيّة لها سوى في ادّعاء «الشرعيّة» ذاتها.
مفهوم «الطرح» يتجاوز المحطات «الخطابيّة» التي هي أقرب إلى ملء الفراغات ولزوميات ما يلزم رغبة في نسج «كلام» أشبه بالآلة الحاصدة التي ينحصر أقصى مرماها في عدم التفويت في أيّ حبّة قمح.
أكثر من ذلك، لا يأتي ذكر البعد الاجتماعي، بمعنى غلاء المعيشة وتردّي القدرة الشرائيّة بفعل التضخّم المالي المواصل، دون أن ننسى فقدان عديد المواد الغذائيّة الأساسيّة، سوى من باب الإشارة إلى «هفوات الطرف المقابل».
«أنصار الشرعيّة» يعتبرون التردّي الاقتصادي من تبعات «الانقلاب»، بل لا يذكرون الفترة السابقة لتاريخ 25 جويلية 2021، كأنّ البلاد كانت جنّة، ومن ثمّة يحصرون «البلاء» بكامله في من أقدم على «الانقلاب»، في حين يؤسّس خطاب «الحركة التصحيحيّة» على تردّي الوضع الذي ورثه عمّن كان قبله، بل يعتبر أو هو يصرّ على اعتبار «الانهيار الاقتصادي» وما نتج عنه من «توتّر اجتماعي»، من أهمّ الأسباب التي دفعت إلى تفعيل الفصل ثمانين، ومن ثمّة يكون وجوب الصبر عليهم لضخامة المسؤوليّة.
 هي حالة انفصام جدّ خطيرة، بين هذه الفواعل السياسيّة ومدى انخراطها في حرب استنزاف الطرف المقابل. على المستوى الوعي الظاهر، هناك تسليم من الطرفين بأهميّة الطرح الاجتماعي، فقط على مستوى المنطوق وليس القرار السياسي الفعلي والفعّال، لمن هو في السلطة… من حكم قبل 25 جويلية 2021 كما من جلس على كرسي السلطة بعد هذا التاريخ، الفقر (الفكري) مدقع، بل هي حالة من «الانكار» بالمفهوم المطروح لدى علماء النفس.
هي حالة انفصام جدّ خطيرة، بين هذه الفواعل السياسيّة ومدى انخراطها في حرب استنزاف الطرف المقابل. على المستوى الوعي الظاهر، هناك تسليم من الطرفين بأهميّة الطرح الاجتماعي، فقط على مستوى المنطوق وليس القرار السياسي الفعلي والفعّال، لمن هو في السلطة… من حكم قبل 25 جويلية 2021 كما من جلس على كرسي السلطة بعد هذا التاريخ، الفقر (الفكري) مدقع، بل هي حالة من «الانكار» بالمفهوم المطروح لدى علماء النفس.
انفصام ثان لا يقلّ خطورة، يكمن في هذه الطبقة السياسيّة برمتها، سواء من يحكم راهنًا أو من كان بالأمس ممكنًا لمقاليد البلد، بين غرقها في مستنقع حروب البسوس من أجل السلطة، من جهة، مقابل «الواقع الشعبي» الذي لا يزال يُعرب عن استقالة تصل حدّ القطع الحاسم مع «الطبقة السياسيّة» بكاملها، بل الأدهى أنّ خطاب الفاعلين ضمن «عراك الثيران» هذا ومشتقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، اعترفت بظاهر اللسان بهذا «الطلاق» إلاّ أنّها عاجزة عن نسج منظومة «مصالحة» مع هذا «المحرّك الشعبي» الضروري، بل هو الحاسم عند المحطات الكبرى، سواء «الانتخابيّة» (عبر التصويت) أو «الثوريّة» (بمعنى تفعيل الشارع).
بفعل الأضواء التي تسلطها وسائل الإعلام، وبحكم الحركيّة التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي، صار اليقين بأنّ «أمّ المعارك» تكمن في «صراع الجبابرة» سوى عبر نزال مباشر بين كلّ راشد الغنوشي وقيس سعيّد، أو «جبهة التصحيح» مقابل «جبهة الخلاص»، وغير ذلك من تدرجات المعركة، لكن «القطيعة الكبرى» (والأخطر) تكمل في الانفصال الذي بدأ يبلغ أشدّه، بين «قاطرة سياسيّة» يتخيّل كل طرف صراع ضمنها أنّ ركّاب جميع العربات تلهج بذكر اسمه، في حين أنّ ركّاب العربات، هم بين «كفر» بركّاب القاطرة بكاملهم، وبين مسعى شخصي ومتواصل لتحصيل لقمة العيش، وقد بلغ اليقين أشدّه بأنّ من يقودون القطار، لا وعي لهم بما يعيشه هذا العمق الشعبي ولا باليأس الذي احتلّ كامل الوعي ومجمل القناعات.
ما هو أخطر لدى العمق الشعبي من هذه «الاستقالة الجماعيّة» التي أقدمت عليها الطبقة السياسيّة بكاملها، يكمن في تنظير العدد الأكبر من هؤلاء الفاعلين، حين يشترطون تحقيق الانتصار على من ينازعون وينازعهم السلطة، بغية التأسيس بعد ذلك (دون وعي بأنّ ساعة الرمل بصدد النفاذ) لما هو مطلوب من «اصلاح اقتصادي» سواء جاء هذا الإصلاح من باب الحدّ من التردّي المتواصل لمستوى المعيشة، أو (وهنا الحلم) التأسيس لمنوال تنمية جديد، يقطع مع إرث الماضي ويفتح الأبواب مشرّعة على الوفاء بالمطالب المرفوعة طوال الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011…
توسيعًا لدائرة الرؤية يمكن الجزم أنّ الانسحاب من أمام «الغول الاقتصادي» ليس وليد اللحظة في تونس، حين راكمت حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 ليس فقط العجز عن التدخّل من باب دورها الشرعي على قاعدة أنّها تملك تفويضًا شعبيا لا لُبس فيه ولا غبار عليها، بل (وهنا المصيبة) انصرف الهمّ في أبعاده المؤسّسة كما تفاصيله، إلى محاصرة جميع الأزمات دون أن وعي/سعي بضرورة حلّ المشكلات من أساسها.
أخطر من ذلك، هاجس البقاء في الحكم كان دائمًا وأبدًا سابقًا لأيّ جهد لتخليص البلاد من أزماتها، بل (وهنا المصيبة) تمّ التضحية بالمصالح الاستراتيجيّة ذات البعد الاقتصادي، من أجل المحافظة على المناصب. مثال ذلك استسهال الغرق في دوّامة الدين، حين كانت الخشية من السقوط ومغادرة الحكم أقوى من الاقدام على قرارات شجاعة وإن كانت مؤلمة.
السؤال الذي يطرح ذاته بشكل منطقي ومستعجل، يكمن في بلوغ البلاد حدّها الأقصى من التداين، بمعنى عجز الاقتصاد في القريب العاجل عن الاقتراض، وبالتالي أيّ الخيارات الممكنة أو المطروحة أمام صاحب القرار السياسي لتفادي «الإفلاس» الاقتصادي وما يتبع ذلك وينتج عنه على المستوى الاجتماعي ومن بعده السياسي.
 جدل مع نصر الدين بن حديد
جدل مع نصر الدين بن حديد