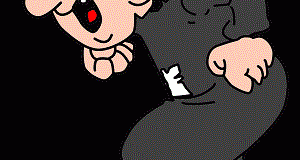عندما أعلن المفكّر الأمريكي من أصل ياباني فرنسيس فوكوياما نظريته الشهيرة عن «نهاية التاريخ» سنة 1992، فهو يعني أنّ الإنسانية وبعد مرورها بمحطات تاريخيّة عديدة، اختبرت خلالها مجمل أنماط الحكم وأشكال الإدارة السياسيّة في أيّ بلد، وصلت إلى قناعة مفادها أنّ النمط الديمقراطي الليبرالي القائم ضمن الفضاء الغربي، لا يمثّل فقط أرقى ما وصلت إليه الانسانيّة، بل هو «نهاية التاريخ»، أيّ استحالة أن تنتج البشريّة نظامًا أفضل، وبالتالي (وهنا لبّ المسألة) يكون «لزامًا» على بقيّة الشعوب (غير الغربيّة) أن تتبنّى هذا النهج (أي النظام الديمقراطي الليبرالي على النمط الغربي).
هذه الخلاصة ليس فقط وجدت ترحيبًا واسعًا من قبل دوائر القرار في الفضاء الغربي، بل ذهب عدد من السياسيين حدّ قول أنّ على (هذا) الغرب أن ينشر هذا النظام سواء بالحسنى والإقناع، أو بالجبر والإلزام، حين وجب «انقاذ الشعوب» من قادتها الذين لا يؤمنون بنظريّة «نهاية التاريخ» هذه.
وجب التذكير أنّ الغرب بنى نظرياته الاستعماريّة وكامل منظومة الاحتلال على «واجب تمدين الشعوب المتخلّفة» أي تطويعها وجعلها ضمن المجال الفكري وبالتالي السياسي الغربي.
اتّكل الغرب بكامله على النفس الفكري الذي أسّست له نظريّة «نهاية التاريخ» ليعيد تلميع ماضيه الاستعماري، وكذلك صناعة/صياغة «استعمار» جديد، قائم على (واجب) «التدخّل لأسباب إنسانيّة»، بمعنى إرسال الجيوش بغية «انقاذ الشعوب».
لمع اسم وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة السابقة مادلين أولبرايت، وخاصّة وزير الخارجيّة الفرنسي السابق الطبيب برنارد كوشنر، الملتحف برداء منظّمة «أطباء بدون حدود»، ومستغلا سمعتها للترويج لما قال أنّه «واجب التدخّل» لإنقاذ من يعيشون تحت أي تهديد.
 مكّنت نظريّة فوكوياما من إعادة «تلميع» الفكر الاستعماري الذي وإن كان ملازما للاستراتيجيات التي رسمتها الدول الغربيّة ومن ورائها الشركات المتعدّدة الجنسيات، إلاّ أنّها (أيّ النظريات الاستعماريّة) خفّ بريقها على المستوى الفكري، ولم تعد أصوات «مرموقة» تمجّد الاستعمار أو تعدّد فضله.
مكّنت نظريّة فوكوياما من إعادة «تلميع» الفكر الاستعماري الذي وإن كان ملازما للاستراتيجيات التي رسمتها الدول الغربيّة ومن ورائها الشركات المتعدّدة الجنسيات، إلاّ أنّها (أيّ النظريات الاستعماريّة) خفّ بريقها على المستوى الفكري، ولم تعد أصوات «مرموقة» تمجّد الاستعمار أو تعدّد فضله.
من ذلك أقرّ البرلمان الفرنسي بتاريخ 23 فبراير/شباط 2005، قانونا ينصّ ويذكّر بمزايا الوجود الفرنسي «الإيجابي» ما وراء البحر وخاصّة في «شمال افريقيا».
دون الجزم بوجود رابط عضوي بين نظريّة فوكوياما وإقرار القانون الفرنسي، إلاّ أنّه يمكن الجزم أنّ القانون ينخرط ضمن المناخ أو هو المسار العام الذي أعادت النظريّة نفض الغبار عنه.
إضافة إلى «تبييض الماضي الاستعماري» صار الغرب أشدّ شراسة للتنديد بالأنظمة التي لا تنخرط ضمن مسار الديمقراطيّة الليبراليّة، وبالتالي تحوّل كلّ مختلف وصار كلّ متخلّف عن «المبايعة»، دكتاتورًا.
نظرة راهنة إلى هذه «الديمقراطيات الليبراليّة» التي جعلت لذاتها مقاما علويّا، جعل منها، أو هي جعلت من ذاتها ذلك «الحكيم المؤتمن على الديمقراطيّة» أينما كانت، تجعلنا نقّر ونقف عند حقيقة لا يمكن انكارها حين اعترف كبار المفكرين في الغرب أنّ «الديمقراطيّة الليبراليّة» تترنّح، بل هي في حال تراجع وعدم قدرة ليس فقط على الحفاظ على بريقها، بل (وهنا لبّ المعادلة) لم تعد قادرة على اقناع شعوبها بأنها «أفضل نظام أخرج للناس»، حيث بدأت نسب المشاركة في الانتخابات تشهد تراجعًا سريعًا ومخيفًا، ولم تعد نسب الراضين على أداء النخب الحاكمة مرتفعة، وصولا إلى نزول أعداد متزايدة من شعوب هذه البلدان إلى الشوارع، وأخطر من ذلك «ممارسة العنف» في ديمقراطيات فاخرت ولا تزال تفاخر بأنّ «العنف (لديها) حكر على السلطة الشرعيّة».
استشراء الغضب داخل البلدان التي طالما فاخرت بأصالة الديمقراطية فيها، وتزايد علامات عدم الرضا، وتفضيل قطاعات تتوسّع هي الأخرى، التعبير عن عدم رضاه في الشارع ومن خلال العنف، وليس عبر صندوق الاقتراع، كما تنصّ جميع الديمقراطيات الليبراليّة، يؤكّد بما لا يدع للشكّ، أنّ الأمر لا يخصّ «شرذمة ضالة تصطاد في المياه العكرة»، ولا «حالات سيكولوجية عابرة»، ولا «مؤامرة تحيكها جهات معادية (روسية خاصّة)»، بل هو سرطان مسّ عمق هذه الديمقراطيات التي صارت عاجزة عن اقناع شعوبها بمزاياها.
استطاعت الديمقراطيات الليبرالية منذ انتهاء الحرب الكونيّة الثانية، نصب ذاتها في صورة المؤتمن على أمرين، أو هي الوحيدة القادرة على تحقيقهما: الرخاء معطوف على الحرّيات في بعدها الفردي والجماعي.
استطاعت فرنسا طوال ما سمّي «الثلاثين سنة مجيدة» Les trente années glorieuses، أن ترفع تدريجيا من مستوى المعيشة وبالتالي نقلت قطاعات واسعة من شعبها من حال الخصاصة والفقر، لتجعل منها «برجوازيّة صغيرة» تمتّعت بمباهج الحياة ونعمت بمزايا (هذه) الديمقراطيّة الليبراليّة.
أزمة النفط سنة 1973، وما تلاها من فكّ الارتباط بين الذهب والدولار، والانطلاق التدريجي والمتسارع نحو «عولمة الاقتصاد»، أدّى إلى تراجع الاهتمام بما كان «مضمونًا» من رخاء للطبقة العاملة، وثانيا توّسع بشكل متزايد المدى المفتوح أمام رأسمال للاستثمار ليشمل دولا أخرى غير الدولة التي ينتمي إليها.
لم تكن أيّ من الديمقراطيات الغربيّة قادرة أو بالأحرى راغبة في الحدّ من التبعات السلبيّة لهذه العولمة على استقرارها الاجتماعي، خاصّة وأن فكّ الارتباط بين الذهب والدولار، وبالتالي مع عملات هذه الدول، مكّن من تأمين «المزايا الاجتماعيّة» التي تحصّلت عليها الطبقة العاملة من خلال الاقتراض المتبوع بطباعة المزيد من العملة لتغطية العجز الذي أصاب الصناديق الاجتماعيّة.
يرى فيلسوف اليمين الفرنسي ريمون أرون، أنّ الغرب لا يخشى الأزمات خلافًا للمعسكر الاشتراكي، لأنّ هذا الغرب (حسب هذا الفيلسوف) قادر على تحويل أيّ «أزمة» إلى «فرصة» ليس فقط لتجاوزها (أي الأزمة) بل للانطلاق نحو أفاق أرحب.
أزمة الديمقراطيات الغربيّة بكامل أطيافها راهنًا ليس في وجود الأزمة بل في انعدام الحلّ أو بصيص أمل في الجمع بين ما كان من رفاه اقتصادي وتسليم الشعوب دواليب الدولة للأنظمة الحاكمة، دون رفض أو مراجعة.
ليست أزمة عابرة أو تخصّ هذا النظام دون الآخر. هي أزمة شاملة وعميقة ومتعدّدة الأبعاد، ممّا جعل الرهان يتحوّل من تأمين الرخاء المادي مصحوبا بما هو طيب العيش، إلى فكّ الارتباط بين الديمقراطيّة الليبراليّة، على اعتبارها أسلوب حكم، من جهة، مقابل ما هو واجبها (أيّ الدولة الديمقراطيّة) من تأمين شروط الحياة الكريمة.
هي «لعبة» استبدال تسعى الأنظمة الديمقراطية الليبراليّة ترسيخها، بمعنى أنّ رفض السياسات الليبراليّة المتوحشة، لا يمكن (حسب رأيها) سوى من خلال صندوق الاقتراع الذي لا يطرح عادة «البديل» بقدر ما هو «المعوّض» الذي يواصل السياسة ذاتها، مثلما هو حال فرنسا خاصّة منذ صعود نيكولا ساركوزي ومن بعده فرانسوا هولند، وصولا إلى إيمانويل ماكرون.
على مستوى الصورة الانتخابية، جاء الثاني نافيا لسياسة الأوّل، ليواصل تطبيقها، وكذلك حال الثالث مع الثاني.
يطرح عجز الديمقراطيات الليبراليّة عن تأمين نفوذها داخل أوطانها أسئلة عن مدى القدرة على تسويق ذاتها ومواصلة اعتمادها، أمام «الدول غير الديمقراطيّة» في صورة المثال الذي وجب تقليده.
على المستوى العالمي، السؤال المطروح يخصّ العلاقة التي من المفترض أن تكون بين الديمقراطيّة الليبرالية على اعتبارها أسلوب فرز للنخبة السياسية ونظام حكم، من ناحية، مقابل ما يمليه «العقد الاجتماعي» ضمن المفهوم الذي أرساه جان جاك روسو، وبالتالي أيّ حدود لشرعيّة من جاء بهم الصندوق إلى السلطة، أمام مشروعيّة شارع يختزن عنفا أشبه بمخزن بارود لا تعوزه سوى شرارة مهما كانت صغيرة؟ حين نعلم أنّ ثلث الشعب الفرنسي صار عاجزًا عن تأمين وجبات ثلاث في اليوم، ونصف الطلبة يكتفون بوجبة واحدة…
السؤال وإن شكّل أرضية لمناظرات تراوحت بين طرحها ضمن أبعاد فلسفية، وبين هواجس الفرد المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائيّة، وما يمثّل الأمر من خطر على الاستقرار الاجتماعي، إلاّ أنه يطرح أسئلة حارقة أمام صعود اليمين المتطرف وأخطر من ذلك تطرّف اليمين التقليدي من باب سحب البساط والاستحواذ على الشعارات المعادية لما هو «الآخر» مهما كانت صفته.
عجز الديمقراطيات الغربية على أن تكون «نهاية التاريخ» (بالمعنى الذي طرحه فوكوياما) طرح ويطرح أسئلة عن البديل، الذي لم يتبلور بعد، خاصّة بعد أن صارت «الشعبويّة» بكافّة أشكالها تختصر المعادلات في صورة لزوميات عنصريّة، تقدّم ذاتها في صورة البديل/المنقذ؟
هذه الضبابيّة بخصوص «ما بعد نهاية التاريخ» يمثّل «جوكر» الذي تمسك به هذه الديمقراطيات (أشبه بالغريق المتشبث بقشّة، وسط أمواج متلاطمة) لتواصل وجودها، حين تقدّم ذاتها في شكل «النظام الأقلّ سوءا» بين الخيارات المطروحة، وأنّ المعضلة لا تعني اختيار من يريد بل في أن ينتقي بين المعروض عليه، وإلاّ كانت الفوضى…
 جدل مع نصر الدين بن حديد
جدل مع نصر الدين بن حديد